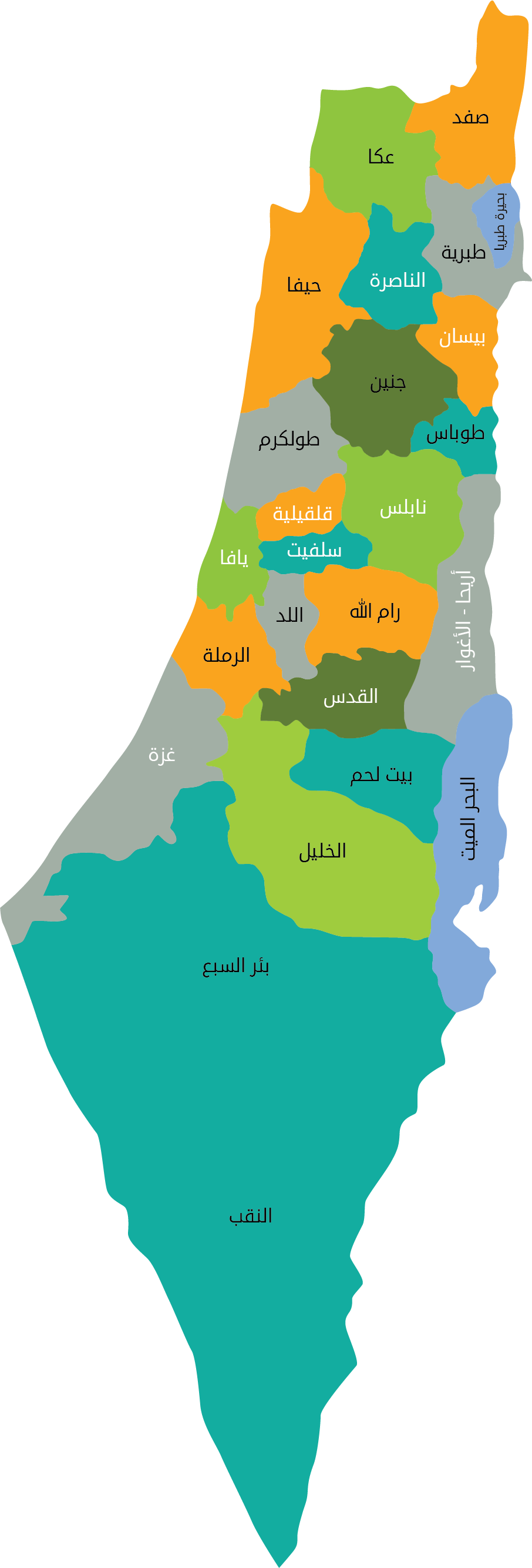إلى القرية المجاورة

كأن مريم العذراء الحامل بالمسيح كانت تعرف وهي تهب على قدميها مسرعة من الناصرة لزيارة قريبتها العاقر والطاعنة في السنّ، اليصابات، الحامل بيوحنا المعمدان في قرية عين كارم المحاذية لمدينة القدس، بأن زيارتها هذه هي ما سيشفع بعد قرابة الألفي سنة للقرية الصغيرة فلا يسوّي الصهاينة بيوتها بالأرض بعد تهجير أهلها في صيف 1948، خلافاً لما طال بيوت غالبية القرى الفلسطينية التي هُجرت. أُبقيت البيوت المبنية على طراز ما شاع في بعض القرى الفلسطينية كما هي، تفصل أزقة ضيقة بين بعضها، وأخرى تتحلق لتشكل حوشاً حول باحة واسعة، يسكنها الآن من لم يعمّرها.لم تعد عين كارم مزاراً دينياً فحسب بل مزاراً للخيال، نقصدها للانتقال مجازاً إلى القرى التي خربت، فلا يأتي أحد زائراً نواحي القدس إلا ونجرّه مسرعين ليتفرج على عين كارم. لكن "بقاء" عين كارم يستدعي سؤالاً عن واقع القرى الفلسطينية الأخرى التي بقيت وبقي أهلها فيها، فيما فُرضت عليهم المواطَنة الإسرائيلية ليصيروا رعايا الدولة المقامة على أنقاض بلدهم. لماذا لا يشكل بقاء هذه القرى ببيوتها وأهلها مساحة للفلسطيني لاستذكار بلده؟ يأتي الجواب جلياً للناظر إلى هذه القرى، إذ لم تكن هي أيضاً بمنأى عن الدمار. لم تُهدم غالبية بيوتها ولم يُهجّر أهلها، ولكن النكبة قطعت تطورها الطبيعي، فيما دأبت "إسرائيل” على هدم طابعها القروي ومسحه بتحويلها إلى أماكن هجينة عشوائية، معلقة في الهواء، لا ماضٍ يسندها ولا أفق لمستقبل تطاله عيناها.
قرية فلسطينية أم قرية عربية؟
"القرى" أو "القرى العربية"، هي التسمية التي اصطلحت "إسرائيل” على إطلاقها على القرى الفلسطينية الواقعة في أراضي فلسطين المحتلة العام 1948 التي بقيت هي وأهلها. حُوّلت القرى الفلسطينية إلى "قرى عربية" بالمفهوم الإسرائيلي: قرى ترميزاً لـ"التخلف" لا إلى الطابع، وعربية للإشارة إلى كونها "الآخر" المغاير وسط دولة ومجتمع مؤسسين على مقولة "لم يكن ثمّة شيء اسمه الشعب الفلسطيني". أنتجت "إسرائيل” بناء على ذلك حيزاً متجانساً من القرى المعزولة عن سياقها التاريخي السياسي والاجتماعي والاقتصادي لاحتوائها وترسيخ دونيتها.
كان لا بدّ وفقاً لهذا المنطق من تهديم القرية الفلسطينية كمكان معيشي لمجتمع زراعي قوامه الأرض، فصادرت "إسرائيل” الغالبية العظمى من الأراضي الزراعية وفق قوانين طوارئ فرضتها بموجب حكم عسكري دام عشرين عاماً. انحسرت بذلك الأراضي التابعة لكل قرية، سواء كانت خاصة أو عامة، لتبلغ حصة الفلسطينيين من الأرض 3 في المئة فقط من مجمل الأرض المحتلة العام 1948. بقيت هذه الحصة ثابتة لم تتغير، ولم تتوسّع المسطحات البلدية لأي قرية، رغم تضاعف عدد سكانها 16 مرة منذ النكبة، بما في ذلك النازحون الداخليون الذي شُرّدوا من قراهم المدمرة، ليبلغ تعداد الفلسطينيين بالمجمل اليوم في أراضي 1948 أكثر من مليون ونصف نسمة.
كما مَنع منطق التهديم بِناء أي قرية فلسطينية جديدة منذ النكبة، عدا سبعة تجمّعات سكنية أقامتها "إسرائيل” على أراضي بعض القبائل البدوية في صحراء النقب لتركيز كل القبائل فيها والتخلص من "مشكلة ادعاءات ملكيتهم في أراضي النقب". فيما انتهجت إلى جانب ذلك سياسة الاعتراف بقرية دون أخرى، متلاعبة بموجبها باحتساب قرية ما على أنها "شرعية" أو عدم الاعتراف بأخرى بتاتاً. اعترفت "إسرائيل” بـ135 قرية تحت نظام حكم مجالس محلية منتخبة مباشرة من الأهالي، فيما ترفض الاعتراف مثلاً بعشرات القرى البدوية في صحراء النقب، والتي باتت تُعرف بـ"القرى غير المعترَف بها"، حتى على لسان أهلها. لا تقتصر إسقاطات عدم الاعتراف بالمكان على تدمير طابعه القروي أو البدوي، وإنما على قابلية المكان ذاته للعيش فيه، إذ يفتقد للكهرباء والماء والتصريف الصحي، ناهيك عن تدمير المحاصيل الزراعية، ما يعني سدّ الطريق بين الإنسان وأرضه وهو فيها لا يبارحها.
تستغلّ "إسرائيل” مؤسسات التخطيط والبناء التي تنظم المساحات السكنية والزراعية والصناعية، بناء على خرائط هيكلية ومخططات معمارية، للإمعان في تدمير القرى الفلسطينية. فهي أبقت الأخيرة على هامش أي تخطيط أو تنظيم. يكفي أن نذكر مثلاً غياب أي مخططات تنظيمية لها منذ سبعينيات القرن الماضي. حوّلت هذه السياسة الفلسطيني إلى مشكلة وحمّلته مسؤولية تخريبه لقريته، إذ بات يبني أينما وجد رقعة أرض من دون "ترخيص"، ما يعتبر خرقاً لقوانين التنظيم وبالتالي يكلف من اضطرته الحاجة الطبيعية لبناء مسكن له ولأبنائه غرامات باهظة وتهديد دائم بالهدم. عليه، فإن الاعتراف ذاته بالقرى لم يكن إلا شكلياً بما يتعلق بمقدرة أهلها على التأثير ــ عبر السلطات المحلية المقامة ــ على حيّزهم وإمكانية خلق تطوّر قروي. هو مقتضَب أصلاً في ظل تآكل الأرض.
عادة ما تُسرد هذه المعطيات دون الكشف عن المشهد المتكدّس تحتها وعن إسقاطات هذه السياسات على أرض الواقع. يبدو تشوّه الحيز القروي جلياً للعين إذا مرّ أحدهم بمحاذاة إحدى القرى الفلسطينية، والتي يمكن تمييزها عن البلدات الإسرائيلية التي أقيمت على أراضيها أو أراضي أخرى مدمرة، بحيث تطورت كل من هذه البلدات وفق الطابع الذي اختارته لنفسها.
باتت القرى الفلسطينية مشهداً متناقضاً متكرراً من الأبنية المتراصة فوق بعضها البعض من جهة والفيلات الفخمة في جهة أخرى، تجانبها متاجر التسوق العملاقة والمقاهي ونوادي الرياضة، التي جاء بها مستثمرون فلسطينيون في ظل تنامي أنماط استهلاكية عالمية. مسح ذلك خصوصيات معالمها القروية التي ميّزت إحداها عن الأخرى، وأعاد إنتاج علاقتها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، مثقلاً إياها بالفقر والبطالة وتفشي العنف والمخدرات والحمائلية والطائفية مؤخراً، التي تُفتت المجتمع الفلسطيني من الداخل وتهدمه.
"أجت إسرائيل"
تبات المخيلة عضواً مبتوراً في هذه القرى المعلقة "خارج المكان" والزمان، تعوض غيابه بأسئلة تعود بك إلى ذلك العام متلمساً طريقاً لم يعد يسلكه الكثيرون. "يا عمتي شو صار بالـ"ثمانية وأربعين" في عَرابة؟". سألت مرة عمّة والدي السبعينية عن قريتي عرابة البطوف، إحدى القرى التي بقيت في شمال فلسطين. فاستهلت حديثها قائلة "أنا عارفة يا عمتي.. فات أبوي على الدار هاضاك النهار، وقال لنا أجت إسرائيل..".
تشرح صورة "مجيء إسرائيل" إلى القرى الفلسطينية عبثية الانتقال بين عالمين من دون أن يترك الناس قراهم، وتحدد ذلك العام على أنه اللحظة التي أفقدت القرى الفلسطينية سياقها، بفقدانها جمعيتها ووحدتها كوطن وكمجتمع. وإذ نقول لحظة فهي ليست عنواناً لحدث وانتهى، إذ يشكل فقدان السياق سيرورة مستمرة تتمثل بتخلخل الرابط بين الواقع اليومي للقرى الفلسطينية المتبقية والنكبة و"مجيء إسرائيل".
ففي الوقت الذي يملك فيه اللاجئ عنواناً يعود إليه، ولو مجازاً وأحلاماً، يضطر الفلسطيني "الباقي" للتعامل مع قريته كمعطى حياتي ومكان مشغول بالهموم اليومية التي يفرضها "مسموح وممنوع" المنظومة الاستعمارية. هكذا تُبنى المفارقات. مقابل ذاكرة القروي الفلسطيني في الشتات التي تتميز وفق دراسات التاريخ الاجتماعي باستذكار المعالم الجغرافية التي شكلت المكان، ودلالات كوّنت عالمه الفعلي، فيذكرها باسمها وموقعها والطريق إليها، لا يملك ابن القرية المتبقية أي ذاكرة أو مخيلة مكانية شبيهة تعزز رابطه بفلسطين الماضي والمستقبل.في مكان ما هناك، في مخيلة الشتات الفلسطيني، ظلت القرى الفلسطينية المتبقية أمكنة "صامدة" ساكنة لا تتبدل، في حين تمرّ فعلياً بعملية تدمير يومية تستنزف كل معناها كقرية فلسطينية.
من هنا بقيت هذه على هامش التأريخ الفلسطيني عن النكبة الذي تَركَّز بطبيعة الحال على دمار القرى والمدن الفلسطينية الأخرى وتشتيت أهلها. أربك ذلك العلاقة التي تجمع الفلسطيني الباقي في قريته مع النكبة كحدث مؤسس في حياته، بحيث لم يعد يرى هو ذاته أصول أزماته اليومية مع المكان كجزء من دمار أحدثته النكبة. تُضاف إلى ذلك منهجية طمس التاريخ الفلسطيني في وعي الفلسطينيين عبر مناهج التعليم والترميزات الصهيونية المهيمنة وغيرها من سياسات "إسرائيل” لمحو الذاكرة، التي تغيّب بطبيعة الحال الرواية الفلسطينية، وتعززها بخطاب أقلية دخيلة على أرض ليست لها.
القرية المجاورة
هناك قصة قصيرة جداً لفرانز كافكا اسمها "القرية المجاورة" هي كالتالي: "اعتاد جدي القول إنَّ الحياة قصيرة حدّ الذهول، إنها تزحم رأسي الآن بذكرياتها حتى أنني بالكاد أتصور كيف يقرر شاب، مثلاً، ركوب فرسه حتى القرية المجاورة من دون خوف – بغض النظر عن الحوادث الأليمة – فحتى مدة الحياة العادية المليئة بالسعادة لا تكفي مثل هذه الرحلة".لا تستغرق الطريق من القدس إلى عين كارم، أكثر من ثلث ساعة بالمجمل. فيما تستغرق الطريق من القدس إلى الجليل في شمال فلسطين، بين الساعتين والثلاث ساعات. ففلسطين صغيرة في نهاية المطاف. إلا أن الإحساس بالوصول هو أقل ما تشعر به لحظة دخول أي من هذه القرى، إذ تبدو كأنها "قرية مجاورة" يستحيل الوصول إليها، وقد تبدد المعنى الذي كانت تحمله يوماً أو ذلك الذي كان لها أن تحمله. القرية المجاورة هي عنوان الاغتراب في بلد لا تصله، أنت "الباقي" فيه.
المرجع: لاجئ نت